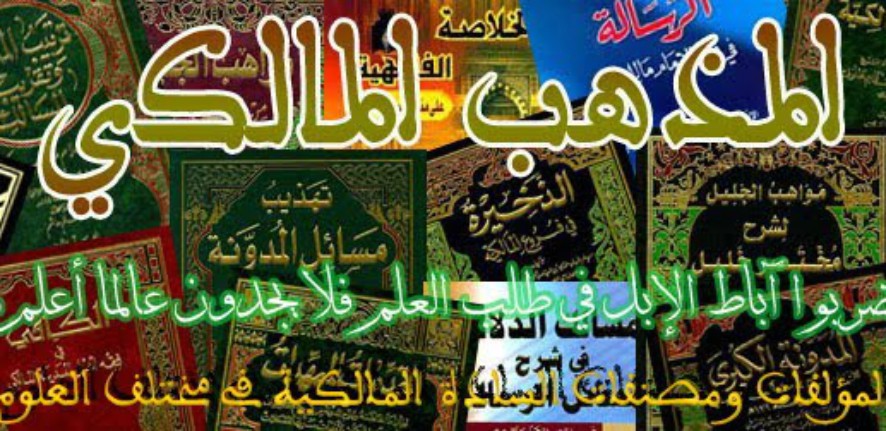هكذا أضفى المذهب المالكي الشرعية على الحكم بالمملكة المغربية الشريفة
لعب الفاتحون العرب دورا أساسيا في نشر الدين الإسلامي بوصفه عقيدة دينية وسياسية تقوم بالأساس على فكرة التوحيد؛ فالدعوة الإسلامية لم تكن فقط دعوة للإيمان بوحدانية الله، بل كانت دعوة تهدف إلى خلق “أمة واحدة منسجمة تؤمن بالله الواحد وترتبط بمصير مشترك تتجاوز بذلك التعددية القبلية وتعدد مراكز السلطة”.
لذا فتجاوب المغاربة مع هذه الدعوة لم يكن بسبب قوة “سيف الفتح” فقط؛ بل أيضا لأن المفاهيم التي تتمحور عليها هذه الدعوة كانت تتلاءم والاتجاه التطوري، الذي كان ينحوه المغاربة نحو التوحد وخلق أمة متماسكة.
هناك عدة عوامل ساعدت على ترسيخ المذهب المالكي بالمغرب، والتي يمكن أن نصنفها في ما يلي:
أولا: العوامل الإقليمية التي تتحدد في الدور الكبير الذي لعبته الخلافة الأموية بالأندلس في انتشار المذهب المالكي بالمغرب وتبعية بعض الإمارات المغربية لسياستها.
ثانيا: العوامل الفكرية التي تتلخص في اتصال المغرب المباشر والمتصل بالشرق الإسلامي، وخاصة شبه الجزيرة العربية.
ثالثا: العوامل الجغرافية، والتي تتجسد في الهيمنة شبه التامة للمذهب في منطق المغرب العربي.
رابعا: طبيعة المذهب الفقهية.
لـكـن الـعامـل الـحاسـم فـي تـرسـيـخ هـذا الـمـذهـب بـالـمـغـرب كان هو “حمل سلاطين المغرب رعاياهم على الالتزام به…مـسـانـدة السلطة للمذهب واعتمادها عليه”. أي بمعنى آخر إن التوظيف الرسمي للمذهب هو الذي أدى إلى ترسيخه في المغرب. وهكذا فقد استخدم المذهب المالكي لتحقـيـق ثلاث مهمات رئيسية:
– إضفاء الشرعية على الحكم
– استخدامه كمصدر للتشريع
– استخدامه في تكوين أطر الدولة
1- المذهب المالكي وإضفاء الشرعية على الحكم
من المتعارف عـلـيـه سـيـاسـيـا أن كـل دولـة هـي قـبـل كـل شيء عنف وتحتاج دائما للشرعية حتى تصبح مستساغة مـن طـرف الـمـحكومـيـن. لذا فقد احتاجت الدولة المغربية منذ بروزها إلى إطار شرعي يغلف مضمونها الحربي والـعـنـفـي. لذا فإن الخاصية السياسية التي ميزت المرابطين، والتي ساعدت إلى حد كبير في نجاحهم، هي هذه الازدواجية التي شكلت أساس مشروعهم السياسي ورافقت تطورهم في إعادة توحيد الدولة بالمغرب.
وتبرز هذه الازدواجية بالخصوص في هذا التقابل بين: عنف / شرعية وأمير / فقيه.
لذا فكل القرارات السياسية التي كان يتخذها الأمراء المرابطون كانت بمشورة وتزكية الفقهاء كمشاورة يوسف بن تاشفين للفقهاء في بناء سور مراكش. وهكذا ساهم هـؤلاء بـدور فـعـال فـي تـسـيـر شـؤون الـدولـة والـحـكـم، بــحـيث كانوا يشاركون فـي مـجـلـس الأمراء ويـرافـقـونـهـم في تنقلاتهم. كما كانوا يشغلون بعض الوظائف السامية، وخاصة في القضاء، ويتقاضون رواتب كبيرة من الدولة.
ولعل هذه المكانة السياسية التي كان يتمتع بها الفقهاء ترجع بالأساس إلى الدور الذي كان يلعبونه من خلال إضفاء الشرعية السياسية على السلطة القائمة. إذ وجد المرابطون في مؤسسة الفقهاء المؤسسة الأساسية التي تضفي على سلطتهم الشرعية اللازمة، وذلك من خلال إصدار فتاوى تزكي السياسية الرسمية وتضفي عليها الشرعية.
وقد استمد الفقهاء هذه “السلطة الإيديولوجية” من تمكنهم من المذهب المالكي وتحكمهم في تقنيات تفسيره وشرحه وتنظيمه؛ لذا فقد انتشرت في العهد المرابطي ما يسمى المصنفات والمدونات والشروح.
وقد أدرك الأمراء الموحدون هــذا الدور الخطير الذي كان يلعبه الفقهاء في إضفاء الشرعية على السلطة القائمة؛ فركز ابن تومرت معارضته السياسية على إظهار ضعف هذه المؤسسة؛ وذلك من خلال الدروس التي كان يلقيها في بعض مـسـاجـد الـعـاصـمـة، ومـن خـلال تـلـك الـمـنـاظرة الشهيرة التي جرت بينه وبين فقهاء الدولة بحضور الأمير علي بن يوسف.
لذا فبمجرد صـعود الموحدين إلى الحكم سعوا إلى اضطهاد الفقهاء المرابطين وملاحقتهم محاولة منهم للقضاء على مظاهر النظام السابق، إذ أحرقت كتب الفروع. “ففي خلافة أبي يوسف يعقوب انقطع علم الفروع وخاصة الفقهاء وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن جرد ما فيها من حديث وقرآن…
وأوقع يعقوب المحن بذوي الفروع وقتلهم وضربهم بالسياط، وألزمهم الأيمان المغلظة من عتق وطلاق وغيرهما على أن يتمسكوا بشيء من كتب الفقه..”. غير أن اضطهاد الموحدين للفقهاء المالكيين لم يكن بسبب الخلاف المذهبي الفقهي بقدر ما كان بسبب الموقف السياسي الذي كان لهم من الدولة الموحدية، كثورة فقهاء سبتة بزعامة القاضي عياض سنة 543 هـ.
كما أن ملاحقة الفقهاء المالكيين في عهد الموحدين لم يكن تحللا من المذهب المالكي الذي بقي المذهب الرسمي للدولة، بل كان مـحـاولـة مـن الموحدين لتأسيس شرعيتهم السياسية على كتاب المهدي والمبادئ الجديدة التي تضمنها. بل ذهب الخليفة يعقوب المنصور أبعد من ذلك بمحاولته عدم ربط شرعية الدولة بمؤسسة الفقهاء؛ وذلك حتى لا يكرر الموحدون الخطأ نفسه الذي وقع فيع المرابطون، وحتى يستطيع احتواء نفوذ الأشياخ الموحدين والحد من سلطتهم.
وهكذا قام الـخـلـيـفـة الموحدي المامون بإلغاء مراسيم المهدوية، إذ أمر بقطع اسم المهدي من الخطبة والتنكر من العصمة والمهدوية؛ فوجه رسالة بهذا الصدد نشرت في مختلف أنحاء الإمبراطورية تضمنت ما يلي:
“مـن عـبـد الله إدريـس أمـير الـمـؤمـنـين ابـن أمـير الـمؤمنين إلى الطلبة والأشراف والأعيان والكافة ومن معهم من المؤمنين والمسلمين (…) ولـتـعلموا أنا نـبـذنا الباطل وأظـهرنا الحق وألا مهدي إلا عـيـسى بـن مـريـم روح الله، ومـا سـمـي مهـديا إلا لأنه تكلم في المهد، فتلك بدعة قد أزلـناها، والله يـعـينـنا على هذه القلادة التي تقلدناها.
وقد أزلـنـا لـفـظ العـصـمـة عـمـن لا تـثـبـت لـه الـعصـمـة، فـلـذلك أزلـنا عنه رسمه، فيمحي ويسقط ولا يـثـبت. وقد كان سيدنا المنصور بالله (رضي الله عنه) هم أن يصدع بما به الآن صدعنا، أن يرقع للأمة الخرق الذي رقـعـنا، فـلـم يساعده لذلك أمله ولا أجله. فقدم على ربه بصدق نية وخالص طوية.
وإذا كـانت العصمة لـم تـثبت عند العلماء للصحابة فما الظن بمن لم يدر بأي يد أخذ كتابه. أف لهم قد ضلوا وأضلوا ولذلك ولوا وذلوا، ما تكون لهم الحجة على تلك المحجة. اللهم اشهد، اللهم اشهد أننا قد تبرأنا منهم تبرؤ أهل الجنة من أهل النار، ونعوذ بك يا جبار من فعلهم الرثيث ولأمرهم الخبيث. إنهم في المعـتـمـد مـن الـكفار وإنا نقول فيهم كما قال نبيك عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا والسلام على من اتبع الهدى واستقام”.
وقـد أدت إجـراءات الـمـنـصور القـمـعـيـة تـجـاه الـفـقهاء المالكيين وسياسة ابنه المامون في إلغاء رموز المهدوية إلى إضعاف شرعية النظام الموحدي؛ وذلك نتيجة ما ترتب عن ذلك من نتائج يمكن حصرها في:
أولا: حرمان الموحدين من سند إيديولوجي تربوا عليه وناضلوا من أجله.
ثانيا: تزعم الفقهاء المالكيين لمعارضة النظام الموحدي.
ثالثا: عدم تماثل هذه السياسية والمعتقدات الشعبية التي كانت متأثرة بالفكر المالكي.
رابعا: التناقض بين سياسة المنصور وابنه المامون.
ولقد أحس الخليفة الرشيد بالمخاطر التي أحدقت بالنظام الموحدي من جراء هذه السياسة؛ فحاول استعادة مراسيم المهدوية من جديد وإعادة الاعتبار للأشياخ الموحدين، في محاولة منه لمواجهة الخطر المريني الذي كان يحظى بمساندة الفقهاء المالكيين.
2- المذهب المالكي كإطار تشريعي للدولة
يتميز المذهب المالكي بمجموعة من الخصائص الفقهية، من أهمها:
أولا: ضبط الأحاديث النبوية التي تم الاتفاق عليها.
ثانيا: الاستناد إلى روايات أهل المدينة وما كانوا عليه من فقه وتشريع ومعاملات.
ثالثا: بساطته.
رابعا: شكلانيته.
خامسا: تقنينه لنمط معيشي.
وتعتبر هذه الخاصية الأخيرة من أهم مميزات المذهب المالكي؛ إذ إن أهم أسس وأصول المذهب تم تدوينها في الموطأ. فقد روى علماء الأخبار أن الخليفة أبا جعفر المنصور العباسي قال لابن مالك: “ضع للناس كتابا احملهم عليه وليكون مرجعا رسميا لهم وقانونا يسترشدون به”.
وبالتالي، فإذا تـمـعـن المرء في كتاب الموطأ سيجده في آخر المطاف عبارة عن “مدونة قانونية” اهتمت بتقنين كل أوجه الحياة التي يجب أن تحدد سلوك المسلم في إطار منظومة اجتماعية – اقتصادية – سياسية معينة. وهكذا كتب الموطأ وفق تبويب قانوني صرف؛ بحيث قسم إلى 28 كتابا وردت على الشكل التالي:
1 – كتاب الصلاة 16 – كتاب البيوع
2 – كتاب الزكاة 17 – كتاب القرض
3 – كتاب الصيام 18 – كتاب المساقاة
4 – كتاب الاعتكاف 19 – كتاب كراء الأرض
5 – كتاب الحج 20 – كتاب الشفعة
6 – كتاب الجهاد أحوال مدنية
عبادات
21 – كتاب الأقضية
7 – كتاب النذور والإيمان 22 – كتاب العـتاقة والولاء
8 – كتاب الضحايا 23 – كتاب المكاتب
9 – كتال الذبائح 24 – كتاب المدبر
10 – كتاب الصيد الـعـتـق
11 -كتاب العقيقة
شعائر دينية 25 – كتاب الحدود
26 – كتاب الأشربة
عقوبات
12 – كتاب الفرائض 27 – كتاب العقول
13 – كتاب النكاح 28 – كتاب القسامة
14 – كتاب الطلاق الديــة
15 – كتاب الرضاع
أحوال شخصية
ويبدو من خلال هذا التبويب أن هناك “خلفية قانونية” حددت وضع المضامين الفقهية للـمـوطأ، يمكن استنتاجها من خلال ما يلي:
أولا: هناك ميادين قانونية محددة ومفصلة.
ثانيا: تبويب كل ميدان إلى مجموعة من الكتب.
ثالثا: تبويب كل كتاب وفق مجموعة من الأحاديث، تشبه إلى حد ما فصول القوانين العصرية.
وهكذا يمكن تحديد هذه الميادين القانونية وفق الشكل التالي:
– من خانة 1 (كتاب الصلاة) إلى خانة 6 (كتاب الجهاد): عبادات
– من خانة 7 (كتاب النذور) إلى خانة 11 (كتاب العقيقة): شعائر دينية
– من خانة 12 (كتاب الفرائض) إلى خانة 15 (كتاب الرضاع): أحوال شخصية
– من خانة 16 (كتاب البيوع) إلى خانة 20 (كتاب الشفعة): أحوال مدنية
– من خانة 21 (كتاب الأقضية) إلى خانة 24 (كتاب المدبر): العـتـق
– من خانة 25 (كتاب الحدود) إلى خانة 26 (كتاب الأشربة): عقوبات
– من خانة 27 (كتاب العقول) إلى خانة 28 (كتاب القسامة): الدية
من خلال هذا العرض يتبين أن الموطأ إطار قانوني يتضمن ضبط وتنظيم مختلف أشكال المعاملات، سواء العبادية أو الشعائرية أو التجارية أو الجنائية، إلى غير ذلك من الميادين؛ إذن، فلا غرو إن اتخذته الأنظمة التي تعاقبت على حكم المغرب إطارا قانونيا وتشريعيا وفرضته في مختلف أنحاء المغرب لتنظيم تعاملات الرعايا وضبط سلوكها.
وقد حرص المرابطون على تطبيق موطأ ابن مالك اقتداء بأمويي الأندلس من جهة واتباعا لإيديولوجية النـظـام الـمـالـكـيـة مـن جـهـة أخرى. وهذا ما يـفـسـر بالـطـبـع انـتـشـار “الـمختصرات” و”المدونات” و”المصنفات” التي لم تكن إلا “اجتهادات” قضائية وفقهية تطلبتها الممارسة القضائية لموطأ ابن مالك.
وقد تابع الموحدون السياسة نفسها باعتمادهم على الموطأ في إصدار الأحكام. فمعاداة كتب الفروع المالكية وتحريقها…لا يدل عـلى معاداة المذهب المالكي، ولكنه يدل فقط على مناهضة المنهج الفروعي الذي جرت عـلـيه تـلـك الكـتـب… بــدلــيـل اعـتـمـاد الـموحدين عموما موطأ مالك أصلا من أصولهم والدرس الدائب له… أي بمعنى آخر فالاختلاف العقائدي والإيديولوجي مع المرابطين وفقهائهم لم يمنع الموحدين من اعتماد الموطأ كإطار قانوني وتشريعي للدولة.
وبعد صعود المرينيين إلى الـحـكـم أصـبـح المذهب المالكي المذهب الرسمي للدولة بدون منازع، بحيث “أصبح في هذا العهد كامل السيادة، ولم يعد ينافسه أي مذهب ديني آخر”.
ولعل ما يظهر ذلك انتشار المصنفات الفقهية التي تفسر المذهب المالكي والموطأ بصفة خاصة. وهكذا أشار حركات إلى أن بداية العهد المريني تميزت بوجه خاص “بكثرة المؤلفات في الفرائض، وتعددت الشروح الفقهية وبوجه خاص على الرسالة ومتن خليل، وتعددت التقاييد على المدونة وكراسي تدريسها”.
ويمكن تفسير هذه “الفورة الفقهية” بالعوامل التالية:
أولا: مساندة الفقهاء المالكيين للمرينيين في صراعهم مع الموحدين.
ثانيا: تبني المرينيين للمذهب المالكي.
ثالثا: توحيد المرينيين لنظام التشريع والقضاء.
وقد تضافرت هذه العوامل مجتمعة لهيمنة المذهب المالكي في الميدان القانوني والقضائي؛ حيث أصبح في عـهـد المرينيين يسيطر وحده في ميدان التشريع والعبادات مثلما كان الأمر في عهد المرابطين. بل إن المرينيين عملوا في إطـار تـوحـيـدهم للنظام القضائي بالمغرب على محاولة تعميم “تطبيق المذهب المالكي في سائر المحاكم المغربية”.
3- المذهب المالكي وتكوين أطر الدولة
نظرا للمهام الجديدة التي أصبحت تقوم بها الدولة في ميدان التسيير والتنظيم الإداري، اهتم الحكام المغاربة بتكوين مجموعات من الأطر لشغل الوظائف الإدارية والعلمية.
تخريج الأطر الإدارية
بخلاف المرابطين الذين لجؤوا بشكل كبير إلى العنصر القبلي أو إلى استقدام الأطر الأندلسية؛ فإن الموحدين عمدوا إلى تكـويـن أطـر مـحـلـية لتسند لها مهام إدارة الأقاليم وتسييرها. وقد كان الخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي هو الذي دشن هذه العملية، وذلك من خلال اخـتيار مجموعة من العناصر الشابة من مختلف المدن والأقاليم(1) ليتم تكوينها علميا وعسكريا. وهكذا جاء في الحلل الموشية ما يلي:
” ربـى عـبـد الـمومن الحفاظ بحفظ كتاب الموطأ وغير ذلك من تواليف المهدي، وكان يدخلهم كل يوم جـمـعـة بـعـد الـصـلاة داخل الـقـصـر، فيجتمع الحفاظ فيه، وهم نحو ثلاثة آلاف كأنهم أبناء ليلة مـن الـمـصامـدة وغـيـرهـم، قـصـد بـهـم سـرعة الحفظ والتربية على ما يريد، فيأخذهم يوما بتعليم الركـوب، ويـومـا بـالـعـوم فـي بـحـيـرة صـنـعـها لهم في تلك البحيرة (…) ولما كمل هذا الأمر فـيـهـم، عـزل بـهـم أشياخ المصامدة عن ولاية الأعمال والرياسة، وقال العلماء أولى منكم فسلموا له الأمر”.
ومن خلال هذا النص يمكن أن نستنتج ملاحظتين رئيسيتين:
* الملاحظة الأولى تتعلق بالاعتماد على كتاب الموطأ في التكوين العلمي والنظري للأطر.
* الملاحظة الثانية تتعلق باعتماد عبد المؤمن على تبرير إزاحة أشياخ المصامدة من مناصبهم بأولوية العلماء بتسيير دواليب الدولة. وهاتان الملاحظتان تبرزان الهدف البعيد المدى الذي كان يسعى إليه الخليفة عبد المؤمن، وهو تكوين أطر للدولة تتميز بحيادها القبلي، وتكوينها العلمي وتدربها على تحمل أعباء الدولة. وقد نجح عبد المومن إلى حد ما في بلوغ هذا الهدف والاستجابة للتطورات الجديدة التي عرفتها الدولة في عهده.
وهكذا يشير العرابي إلى هذا المعطى من خلال ما يلي:
“يبدو أن تـكـويـن الـحـفـاظ(…) قـد أعـطـى نـتائجه الهامة على المستوى الإداري و…المستوى الـتـنظـيمي الـذي هـدف بـه عـبـد الـمومـن إلى خلق جـيل جديد من الأشياخ ذوي التكوين العالي ليتلاءم مـع ظـروف تـطـور الـدولـة الـموحـديـة بـعـد اتـسـاع رقــعـتـها الـجـغـرافـيـة، فـأصـبـحت الدولة الـمـوحـديـة، ومـنـذ عـبـد الـمـومـن، تـسـتـعـين بالحفاظ وتعينهم في المناصب الإدارية والعسكرية الهامة…”.
وقد كان الهدف من إنشاء هذه المدارس هو تحكم الدولة في المجال الديني الذي أصبح يتعرض لاكتساح بعض الاتجاهات الدينية المختلفة. وهكذا أشار تراس إلى أن:
“بـنـاء الـمـدارس لـم يـكـن مـن أجل التباهي والتعبد. فمن خلال هذه المؤسسات التعليمية الرسمية والمراقـبـة كـان الـحكام يراقبون تطور الإسلام المغربي، ويقومون بمواجهة تأثير الزوايا التي بدأت تـنـتـشـر فـي الـمـدن والقـبـائـل، والتي كانت بشكل خاص لا تخضع لمراقبة السلطة المركزية. كـمـا كـانت هذه المدارس تعمل على المحافظة على تطبيق الدين تطبيقا مالكيا يتماهى وإيديولوجية النظام”.
لـذا فـقـد كان الـحـكام المـريـنـيـون يـحـرصون على مراقبة ما يتم تدريسه من مؤلفات وكتب في المذهب المالكي. وهـكـذا أشـار الجزنائي إلى أن “أبا الحسن كان يحرص على أن تقرأ بين يديه المؤلفات العديدة في المذهب المالكي، وكـان يـصـغـي جـيـدا لـما يلقى عليه من أدلة أهل السنة وبيان مذهبهم، فإذا ما عرضت أدلة المعتزلة أو غيرهم من المذاهب الأخرى أعرض عنها ونهى عن الخوض فيها وزجر من تمادى في ذلك”.
وقد كانت هذه المدارس تخرج أفواجا من الأطر العلمية والفقهية التي كان يتم توظيفها في مختلف المؤسسات الدينية التي هي تحت إشراف الدولة، كجامع القرويين. كما كان يبعث ببعض الأطر إلى مختلف الأقاليم لتقلد المناصب العلمية والدينية
- د.محمد شقير
مملكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.م.ش.س
![]()